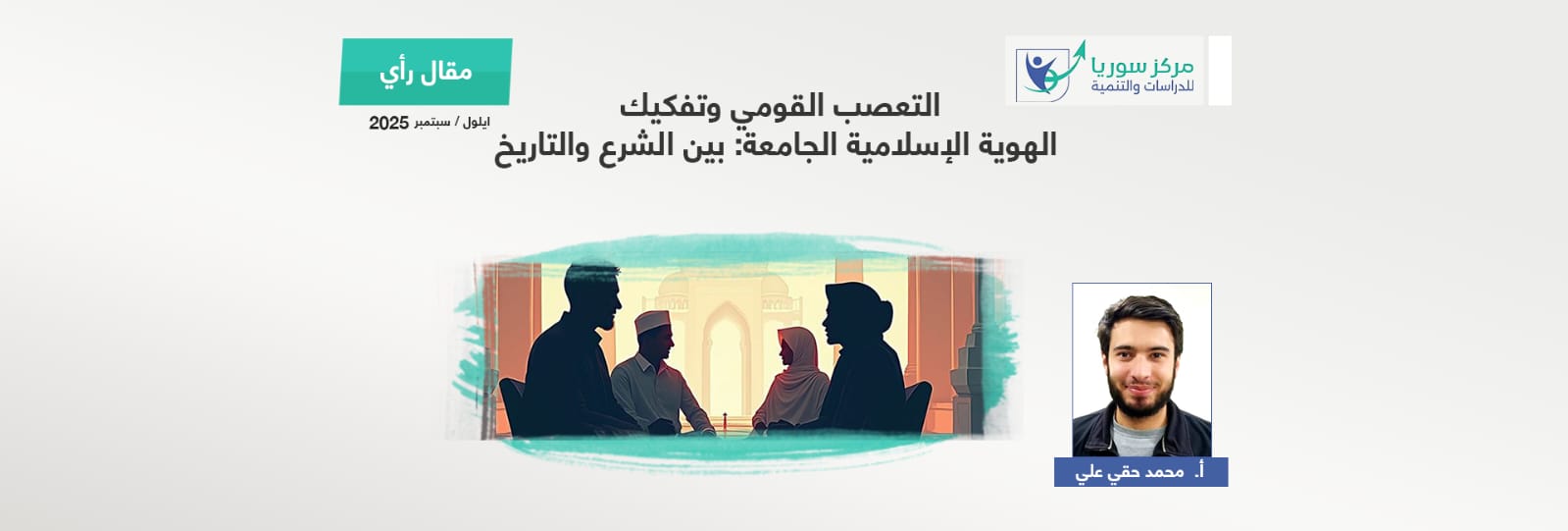يؤدي التعصب القومي إلى تفتيت اللحمة الإسلامية الجامعة، إذ يجعل بعض المتعصبين من قوميتهم أيديولوجيا مغلقة تُقصي كل امتداد ديني أو حضاري، متجاهلين بذلك المقاصد الشرعية والمنهج الفلسفي الذي
يؤسس لوحدة الأمة على قاعدة التعدد المنسجم والانتماء العقدي الجامع. فقد نهى الإسلام عن العصبية بشتى صورها، وحذّر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: “دعوها فإنها منتنة”، وأمر الله تعالى أن يكون الولاء
للعقيدة لا للقبيلة أو الجنس، حيث قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، مؤسساً بذلك للمساواة ونبذ التفاخر.
التعصب يبت الجذور الحضارية والتراثية الأصيلة
إن التقوقع القومي وضيق الأفق لدى المتعصب يحرمان المسلم من نور التراث الإسلامي الممتد عبر الزمان والمكان؛ فحضارة الإسلام لم تُبْنَ على جدران الأعراق والقبائل، بل شُيِّدت بأساس الانفتاح على شعوب الأرض
قاطبة، إذ لم يفرِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العربي والأعجمي، ونشأ خير القرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الكرد والفرس والروم والبربر والترك، وساروا جميعًا في ركب الأمة الراسخة يصنعون مجدها
ويثَّرون ترابها بما حملوه من علوم وصناعات وفنون، وتواصلت حلقات النقل والتلاقح الحضاري في المدارس والحواضر الكبرى من بغداد إلى قرطبة، ومن دمشق إلى القاهرة حتى صار تراث الأمة الإسلامي عنوانًا للامتداد
والجمع، فيسري نورها في الصين والهند والأندلس، ويشع من أعماق تاريخها في صورة مكتبات عريقة وعلوم مترامية الأطراف.
ولولا هذا التداخل الذي مزج الأعراق وصنع منهم أمة واحدة لما كان لتراث المسلمين ذلك البهاء والألق الذي عَمر الأرض، فكم نقل المحدثون والفقهاء الحكم والمعارف من الشعوب المتباينة، ولم تقتصر أوقاف الحق ولا
ميراث العلم على لون أو لسان، وبهذا الامتداد شُيِّدت حضارة جعلت التنوع ركناً من أركانها والتراحم والاتصال سر نهضتها، مصداق ما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: “لا فضل لعربي على أعجمي إلا
بالتقوى”، فكانت إشراقات الأمة تُستقى من جميع أبنائها في ظل وحدة روحية وأخلاقية، ولولا تعدد عناصر الحضارة الإسلامية وانفتاحها وتلاقحها لوأدت بقية الأمم ميراثها بين أيدي المتعصبين.
القومية وعاء اجتماعي لا عقيدة دوغمائية
من المغالطات الجوهرية التي يقع فيها المتعصبون قومياً هو الاعتقاد بأن القومية هي الأصل والمصدر الأصيل، وأنها المبدأ الذي تُبنى عليه الفكرة، وكذلك نهاية القيمة التي يُقاس بها كل شيء. لكن الحقيقة الشرعية
والعقلية مختلفة تماماً، حيث تُعتبر القومية مجرد وعاء اجتماعي يُحتضن فيه الانتماء العقدي، وهي ليست بالضرورة مبدأ ذا قيمة ذاتية أو غاية سامية، بل إطار تُصقل فيه الهوية الإسلامية الجامعة.
قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾، وهذا نص صريح يحث على التعارف والتواصل، وينبه إلى أن اختلاف القبائل والشعوب إنما هو لمصلحة اجتماعية
وبشرية، لا لنشوء عصبيات ممزقة أو أسباب للنزاعات والاقتتال. لذا، فإن الانتماء القومي الطبيعي والمشروع لا يتعارض مع الانتماء الإسلامي، شريطة أن يبقى هذا الانتماء في حدوده المعتدلة ضمن رحابة التعدد
والتناغم مع قواعد العدل والإحسان.
أما أن تتحول القومية إلى أيديولوجيا دغمائية متعصبة فهي أمر يخالف مقصد الشريعة ومقاصد العقل، لأنها تفسد الوحدة التي جاءت بها الرسالة، وتزرع بذور الفِرقة والعداوة بين أبناء الأمة الواحدة. بذلك، لا تكون القومية
هي المقياس الأساسي والغاية القصوى، بل تبقى إطارًا اجتماعياً يُكمل الانتماء العقدي ويمكّنه، من دون أن يتحول إلى سبب إقصاء أو تفريق، وإلا فإن الأمة تفقد روحها الجامعة ومقومات قوتها الحقيقية.
التاريخ شاهد على عقم الفكرة القومية وعدم صلاحيتها
لا يغفل المنهج التاريخي أن مبدأ القوميات المتجاوزة لم يكن من صلب التراث الإسلامي، بل هو نتاج سياق سياسي حديث نشأ مع تشكل الدولة القومية، وما أرسته معاهدة وستفاليا في عام 1648 التي شكلت نقطة
تحول جوهرية في تاريخ العلاقات الدولية وبناء الدول الحديثة. قبل هذا الزمن، كان الولاء في المجتمعات الإسلامية يتحدد أساساً بالانتماء الديني والعقدي الجامعة التي تجمع شتات الشعوب المختلفة على نور الإسلام،
دون أن تُطغى فيها الحدود القومية الضيقة أو الجغرافية كمنطلق للسيادة.
معاهدة وستفاليا أنهت حروب ثلاثين عامًا دموية في أوروبا، وأرسى مبدأ سيادة الدولة الذي يعني أن لكل دولة سلطة حصرية داخل حدودها الجغرافية، دون تدخل خارجي. كما أسست المعاهدة مبدأ “الولاء القومي”
المطلوب للدولة، بدل الولاء الديني أو الجماعي، مؤدية إلى فصل الدين عن السياسة في بنية الحكم الحديثة. هذه التحولات أدت إلى أن يُصبح الانتماء السياسي القومي معيارًا للحكم، مما أوجد حدودًا جغرافية
وسياسية صارمة تُعيق التماسك الاجتماعي والروحي الذي كان سائداً في إطار الوحدة الإسلامية الجامعة.
وحتى السياسة وعلم الاجتماع تنذر بالخطر المحدق
من منظور علوم السياسة والعلاقات الدولية، الدولة القومية التي أسستها وستفاليا تقوم على المفاهيم التالية: السيادة المطلقة للدولة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساواة القانونية بين الدول، إضافة
إلى نظام توازن القوى الذي يمنع هيمنة دولة واحدة على الأخرى. هذه المبادئ جلبت اليقين الدولي والرسمية السياسية، لكنها أيضاً أفرزت صراعات جديدة نتيجة التصادم بين الولاءات القومية المتباينة، ولافتة إلى الحيز
الجغرافي الذي صار محدداً للهوية السياسية، وأحياناً للصراع.
على صعيد علم الاجتماع، فإن تحوّل الولاء من انتماء ديني وروحي متقاطع مع انتماءات متعددة إلى انتماء قومي صِرف أوقع بعض القادة والمفكرين في العالم الإسلامي في فخ التشبث بالجغرافيا السياسية الضيقة
وتعصب القوميات، مما أخفقهم في تحقيق الوحدة والتكامل المنشود الذي نادت به الشريعة الإسلامية وجسدته تجارب التاريخ الإسلامي الناجحة. هذا التشبع بالأيديولوجيا القومية الضيقة قضى على فكرة الأمة الجامعة
التي تتسع للجميع في مسافة عقيدية وروحية، ليصبح الولاء محصوراً في إطار حدود الدولة القومية وتنافسها.
بالتالي، فإن البعد التاريخي والسياسي والاجتماعي لتأسيس الدولة القومية الحديثة يوضح أن القومية باعتبارها مبدأ محصور بالحدود والجغرافيا ليست من صلب الإسلام، بل هي بناء حديث في تاريخ السياسة الدولية،
وهي تحمل من المزايا والقيود ما يجب على العالم الإسلامي إدراكه، والحذر من إغفال وحدة الأمة المستندة إلى الولاء العقدي الجامعة مقابل انغلاق الولاءات القومية التي تقسم الأمة وتبعثر جهودها في زمن تشتد
فيه الحاجة إلى الوحدة والتكامل على أساس إسلامي حضاري بعيد عن التعصب الجهوي الضيق.
خاتمة …. وتوصية
إن الحل الحقيقي للخروج من مأزق التعصب القومي يكمن في التمسك بالوصية الإلهية التي تنهى عن العصبية الضيقة، وتدعو إلى تأسيس الجماعة على أساس الانتماء إلى العقيدة الجامعة التي تتسع لجميع مكونات
الأمة. فالعقيدة الإسلامية تشكل جسرا ممتدا عبر التراث الإسلامي العريق، وترسي قواعد الأخوة والوئام بين كل أبناء المجتمع مهما اختلفت أصولهم وجنسياتهم، فلا مكان لتضييق الأفق أو انغلاق الصدور على التعصب
الجهوي أو القومي الضيق.
إن هذه الرابطة الجامعة تعزز الشمولية التي تنبذ التمييز أو الإقصاء بدعوى العرق أو اللغة أو القومية، فهي تجمع الأمة على كلمة سواء، وتفتح أبواب التراث والحضارة أمام كل فرد كجزء لا يتجزأ من الأمة الموحدة. بذلك
يحفظ المسلم هويته الخاصة، ويغنيها بتاريخ مشترك يمتد من أعماق التاريخ بكل أصالته وعراقته، ويرفد حاضر الأمة بروح من الوحدة والتكامل.
إن عبور هذه المحنة يتطلب تفكيك الأسباب الكامنة في العصبية، والاعتراف بأن الإسلام ينادي بالرحمة والعدل والتسامح كأسس للعلاقات الإنسانية، وأن التمسك بهذه المبادئ هو ما يجعل الأمة تصمد أمام التحديات،
وتستمد عزمها من ماضيها المشرق ومستقبلها الواعد. بهذا تستعيد الأمة عافيتها وتتقدم نحو الوحدة التي لا تعني محو التنوع، بل الاعتراف به وتوظيفه في بناء كيان متين متماسك يستوي فيه الجميع تحت ظل
العقيدة الجامعة وإنسانية الرسالة السمحة.